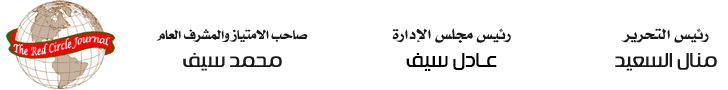لا أدرى لماذا أضحك ، كلما رأيت أنفار الدراس صائمين ، يواجهون العطش فوق التعب ، متناسين تلك الكورونا ، أضحك لأننى كأنى أسمع عبد الوهاب ، يترنم أنشودته الرائعة ، محلاها عيشة الفلاح ، يتمرغ والأرض براح .
عبد الوهاب الذى رافق شوقى بك أمير الشعراء ، وتربى فى القصور ، وتنزه بكل عواصم العالم وحواضرها ، لكنه نظر إلى الفلاح وهو جالس تحت التوته ، تداعبه نسمة رقيقة ، بينما المسكين غارق فى عرقه ، تحت وهج الظهيرة .
تذكرت عيشة الفلاح بينما استيقظت اليوم مبكراً ، أنظر مشاتل الأرز ، ودراس الغلال التى عطلتها أمطار منسية ، فهالنى مشية أحدهم ، يحجل ويقفز ، كمِشية الغراب ، فقلت له : ما بك ؟ فقال : أصابنى جذر قمح ، دخل فى قدمى ، ويبدو أنها التهبت ، فقلت لمَ لا تستريح يوماً أو يومين ، فضحك وطأطأ رأسه ، كمن لا يجد رداً ! .
لكنى فهمت قصده ، فكثير من الكلام ، هو ما لم نقله ، وكثير من الأوجاع هى ما نكبتها ، وكثير من الأحاسيس عنوانها الصمت ، فهمت أنه يقول : أنت غبى ! ، مع أنى لست كذلك !
كيف يستريح ووراءه أفواه وبطون ، وشيكات مستحقة من زيجة البنات ، وأخري تلاحقهن بجهاز ليس أقل من سابقتهن ، علمت أن لكل منا أطفال عيونهم مفتوحة على الجيران والأصدقاء ، يتشبهون بهم فى الملبس والمأكل ، فمن أين له بخمسة وعشرين جنيها ؟ ثمن 2 ك خوخ أو جوافة ، أو 80 جنيها ثمن 2 ك سمك ، وظللت أعداد من أين ؟ ومن أين ؟ .
إلى أن تذكرت أنى ذات مرة قرأت ، أن عبد الوهاب ، صاحب نظرية محلاها عيشة الفلاح ، كان بإسبانيا ، فى إحدى أسفاره وكان بميناء بلنسيه يستعد لركوب السفينة إلى الإسكندرية – لأنه كان يخشى ركوب الطائرة – ، ووصلت السفينة وتوشك أن تبحر ، وهو بالحمام ، فدقوا عليه الباب ليلحق بالسفينة ، فلم يأبه ، وزجرهم بعد ما قضى حاجته ، ولم يلحق بالسفينة ، فأنى للباشا أن يشعر بالفلاح ؟.
وضحكت كأننى أرى الباشا بياقته البيضاء ، وأنفه المدققة ، نظارته الذهبية ، شايل غُمر غلة ، والعرق يتساقط فى عينيه ، و يمشي حافيا على جذور الغلة كأنها سكاكين ، و نزل يلوط المشتل .
لكنى أحبه ، وتمنيت لو سمعتم ( الجندول) ، أو (خى حبيبي لى أسى ) ، أحبه كتاريخ لمصر الجميلة ، ولأخلاق الباشوات التى تأبى التدنى .
رمضان كريم
 جريدة الدائرة الحمراء فى قلب الحدث
جريدة الدائرة الحمراء فى قلب الحدث